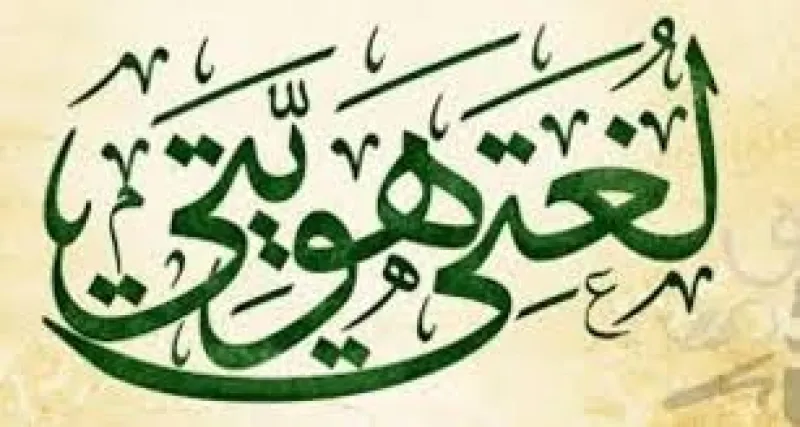
لغتي هويتي
بحث بقلم الدكتور مصطفى القاسمي
مقدمة
اللغة في البدء والانتهاء، هي الثقافة، وهي الحضارة، وهي العلم، وهي التنمية، وهي التفكير، وهي التعبير.. هي الشخصية بكل قسماتها، وسماتها، وذاكرتها، وفلسفتها، ورؤيتها. هي مرآة الأمة، تعكس حركتها وتاريخها، وحاضرها وقيمها، ووجهتها المستقبلية. وهي مرقاتها (وسيلة رقيها) في الوقت نفسه. وإذا لم تدرك العلاقة التبادلية بين اللغة والأمة تحصل الكارثة الثقافية والمعرفية. فاللغة تضعف وتتراجع بضعف الأمة([1]).
ولأن قومنا في سكرة الإعجاب ونشوة الانبهار بكل ما هو غربي، قد حسبوا أن إدراك الشأو الأوربي أو الأمريكي، يعني الانخراط في الحياة الغربية والانخلاع من الحياة العربية.
لقد جاء الاستعمار قبل أكثر من مائة عام، فاحتل أرضنا وأكرهنا على ترك لغتنا والتحول إلى لغته في مراحل التعليم كلها. وفي غمرة الضعف والانكسار خضعنا وقبلنا ([2]).
إن أهم شهادة معاصرة رصدت التحيز في الثقافة العربية لصالح النموذج الغربي، تمثلت في ندوة جامعة عقدت بالقاهرة عام 1992.وثَّقت الظاهرة وأثبتتها في مختلف نواحي المعرفة، ذلك أننا حينما نتحدث عن اجتياح التغريب لمجتمعاتنا العربية كثيرا ما نركز على مظاهر الحياة والسلوك. وهذا حق لا ريب فيه، لكننا لا نركز عادة على مظاهر التغريب في حياتنا الثقافية والعلمية، مثل الانحياز الحضاري الغربي في النماذج الرياضية والعلوم الهندسية والعلوم الطبية وفي التعامل مع التكنولوجيا والتنمية، وصولا إلى علم النفس ونظم المكتبات ([3]).
يحاول هذا البحث أن يطرح بعض التساؤلات ويجيب عنها:
أولا: ما العوائق التي تحول دون التعليم باللغة العربية؟
ثانيا: هل العلوم – فعلا – لا يمكن أن تعلم إلا بوساطة لغتها الأصلية؟
ثالثا: ما أسباب استعمال اللغة الأجنبية في التعليم بديلا عن اللغة العربية؟
رابعا: ما مخاطر التعليم باللغات الأجنبية على أهل اللغة العربية؟
خامسا: ما أهمية التعليم باللغة العربية في نهضة الأمة العربية والإسلامية؟
أولا- العوائق التي تحول دون التعليم بالعربية:
1- عوائق نابعة من القائمين على شأن اللغة العربية:
نحن نعلم أن علوم اللغة غير اللغة نفسها، ووسائل تعلم اللغة وتعليمها ليست بتعلم وسائلها فقط، إنما يتحصل تعليم اللغة بتعود النطق والسماع والإلقاء والحوار والمناقشة والمثاقفة. أو بإتقان المهارات الأربع المعروفة: القراءة والكتابة، والاستماع والحديث.
فعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وغيرها، إنما تكون لحماية اللغة واستقامتها من اللغو واللحن. ولكنها لا تنشئ لغة. فكم من أناس يحفظون قواعد اللغة ولكنهم لا يحسنون أي إنتاج لغوي في فنون القول المتنوعة.
والعربي يدرس اللغة العربية في جميع مراحل الدراسة، وعلى الرغم من ذلك لا يجيدها في النهاية، فلا يحسن الحديث، أو الكتابة بالعربية السليمة. فضلا على أن تكون العربية الصحيحة له سليقة ([4]).
لقد أصبح الفكر يتجه إلى قواعد اللغة وسلامتها أكثر من أن يتجه إلى تفهم اللغة وتذوقها. ووصلت الأزمة إلى أن مدرسي العربية يدرسونها باللغة العامية في المدارس والمعاهد. إضافة إلى ذلك فإن غياي القدوة اللغوية وعلى وجه الخصوص في وسائل الإعلام المختلفة، يؤدي إلى ضعف بيِّن لموقف اللغة العربية.
أما على مستوى التعليم العالي والجامعي، فقد حان الوقت إلى الانتقال إلى مرحلة التطبيق والالتزام بالتنفيذ، وتجاوز مرحلة الدعوة فقط إلى تعريب العلوم. ومن هنا تأتي أهمية تعرف العقبات التي قد تعترض تعريب التعليم من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجتها والتغلب عليها. وتشمل هذه الصعوبات العديد من جوانب التعليم، إذ إنها ترتبط بعناصر التعليم نفسه من أساتذة وطلاب ومراجع، بالإضافة إلى المصطلحات العلمية.
أما المشكلة الأولى التي تتعلق بالمصطلح العلمي، فإنها تبرز من خلال عدم توفر مصطلحات علمية باللغة العربية واضحة وسهلة ومتفق عليها، إذ تتباين المصطلحات من بلد إلى آخر، وقد تختلف أيضا داخل البلد نفسه مما يؤدي إلى عدم توحيدها، وتتضح المشكلة أيضا من خلال التفاوت الموجود في أسلوب كتابة الصيغ والرموز لهذه المصطلحات.
إلا أنه يمكن التغلب على هذه الصعوبة بوسائل متعددة، منها على سبيل المثال، الاستفادة من المعاجم العلمية العربية التي يمكن أن تكون دعامة قوية لبدء حركة التعريب. كما يمكن التغلب عليها من خلال تعريب المصطلحات العلمية الجديدة، خاصة أن اللغة العربية مرنة، إذ يمكن ترجمة المصطلح الأجنبي بمعناه، إذا كان قابلا للترجمة، أو اشتقاق لفظ عربي مقارب له، وإذا تعذر ذلك فإنه يجوز استخدام المصطلحات بألفاظها الأجنبية حتى يتوفر المصطلح العربي المناسب الذي قد يتحقق عن طريق الممارسة المستمرة للتدريس الجامعي والبحث العلمي والتأليف باللغة العربية ([5]).
بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود الكبيرة يجب أن تتجه إلى تعريب الفكر العلمي لنقل المعارف وتأصيل المنهجية العلمية في الفكر العربي ([6]).
أما المشكلة الثانية التي تواجه التعريب فهو عضو هيئة التدريس الذي تلقى علومه بلغة غير العربية، الأمر الذي يعيق تدريس العلوم المرتبطة باختصاصاتهم وكتابة بحوثهم بشكل مرضٍ، بالإضافة إلى أن العديد منهم لم يتقنوا اللغة الأجنبية كتابة وشفاهة خلال فترة دراساتهم العليا. عندئذ يمكن تصور مدى الانخفاض الذي سيكون عليه التعليم والمستوى العلمي([7]).
إن القناعة بضرورة التعريب، ووجود الدوافع الكافية بين أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي والجامعي، من أجل بذل الجهد اللازم للتعريب شرطان أساسيان لكي نضمن نجاح أي برنامج يهدف إلى جعل اللغة العربية لغة التدريس والبحث العلمي في جميع مجالات العلوم ([8]).
ويعتبر الحل الناجع لهذه المشكلة هو اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس والبحث على نطاق الوطن العربي لتحقيق الفائدة المرجوة بين أصحاب الاختصاص الواحد، كما يمكن تنظيم دورات وندوات مستمرة يكون الهدف منها معالجة القضايا اللغوية المرتبطة بالتعريف والترجمة ([9]).
إن عضو هيئة التدريس الذي يستوعب مادة تدريسه، ويحقق مستوى علميا ممتازا في تدريسه الجامعي بلغة أجنبية، سيرتفع مستوى تدريسه عندما يعبر باللغة العربية، لغته القومية. والسبب في ذلك أنه بحاجة أولا إلى استيعاب المضمون في مصادره الأجنبية وفهمه وهضمه، ثم التعبير عنه باللغة العربية ([10]).
المشكلة الثالثة: تتصل بالطالب الجامعي، فالذين يعارضون التعريب يرون أن تدريس المناهج العلمية باللغة العربية سيعزل الطالب عن الفكر العلمي العالمي، وأنه سيحجب فرص الالتحاق بالجامعات الأجنبية لمواصلة الدراسات العليا. ومن ناحية أخرى، فإن مؤيدي التعريب يؤكدون على أن التعليم باللغة القومية يضمن السهولة في التعليم والسرعة في الفهم والاستيعاب أكثر من الدراسة باللغة الأجنبية، ولا يعني هذا إهمال اللغة الأجنبية أو التقليل من شأنها.
إن الارتقاء بمستوى الطالب اللغوي والعلمي يتطلب العناية بتدريس اللغات الأجنبية طيلة فترة الدراسة الجامعية (باعتبارها لغة بحث)، وذلك لرصد المصطلحات العلمية ومتابعتها في مجال تخصصه إلى جانب المصطلحات العربية ضمانا لمواكبة التقدم العلمـي، كما يمكن تكليف الطالب بكتابة بحوثه باللغة العربية وبترجمة بعض الأجزاء المتعلقة باختصاصه مستعينا بمصادر عربية وأجنبية حتى يعتاد أسلوب البحث العلمي والاطلاع على مجالات مختلفة باللغتين ([11]).
أما المشكلة الرابعة، فتتعلق بالكتاب الجامعي حيث تعاني المكتبة العربية نقصا واضحا في المراجع والكتب في جميع فروع المعرفة العلمية الأساسية. وللتغلب على هذه المشكلة، فإنه يجب أن تتحدد احتياجات التطور العلمي والتقني حتى يمكن تلبيتها عن طريق الترجمة والتأليف باللغة العربية لتكون المصادر في متناول الطلاب والباحثين والأساتذة بصفة مستمرة. وحتى تتم عملية تعريب الكتب في التخصصات المطلوبة، يفضل أن يلقي الأستاذ الجامعي محاضرته باللغة العربية لكي يضمن استيعاب الطالب، مع ذكر المصطلحات الأجنبية بين الحين والآخر بدلا من إلقائها بلغة لا يفهمها الطالب، ثم يقرأ كتابا يحول دروس العلم عنده إلى بحث في قاموس ([12]).
2- عوائق نابعة من عدم التنسيق بين المؤسسات التي تبنت قضية التعريب:
فالمؤسسات التي تبنت قضية التعريب في الوطن العربي ليس بينها تنسيق، بل إنه مع جهدها المشكور الذي تبذله، فإن عملية التعريب لا تنفذ بسرعة تواكب سرعة التطور في المجال المعرفي والعلوم الحديثة، بسبب نقص الإمكانات المادية، كما أنه لا توجد سلطة سياسية في الوطن العربي تتبنى قضية التعريب وتنفذه باعتباره واجبا قوميا ملزما.
والذي يعنينا من إشكال التعريب هو العودة باللغة العربية إلى وضعها التعبيري الشامل، وذلك بتطويعها لاستقبال الوافد الأجنبي، والتمكين للغة العربية في المجتمع العربي في مرافقه المختلفة لا يتأتى إلا باتخاذ القرار السياسي، الذي يجعل من اللغة العربية اللغة الأساسية في المحيط الإعلامي والتعليمي والاقتصادي. وهذا التمكين للغة سيفضي بها لا محالة إلى نمو داخلى وتقوية ذاتية، وتطوير لوسائل مواكبة العصر واستيعاب المستجدات.
إن التعريب المرجو الذي يحقق نهضة الأمة، لايقف عند مجرد إحلال العربية محل الأجنبية في الإدارة والتعليم والاقتصاد، ولكنه يتعدى"تعريب التعبير" إلى "تعريب التفكير".
والتعريب المرجو هو الذي يخلص الأمة من التبعية الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية للغرب، ويضمن لها خصوصيتها وتفردها وإثبات ذاتها.
والتعريب المرجو هو الذي يراد منه للعربية أن تتبوأ مكانها الطبيعي، فتكون اللغة الأولى في الحياة والمجتمع والعلم والتعليم، أما اللغة الأجنبية فينبغي أن تعطى قدر ما تستحق، دون تغليبها على اللغة الأولى ([13]).
1- عوائق نابعة من تيار التغريب:
إن أزمة الأمة تجاه اللغة العربية يتمثل في أن تيار التغريب أقوى من أجهزة الدولة ومؤسساتها التنفيذية، ودليل ذلك:
أ- صدور قرار جمهوري عام1958 يوجب لاستعمال العربية في المكاتبات واللافتات.
ب- للمجلس التنفيذي والشعبي في مصر قرار مماثل عام 1991.
ولم ينفذ من ذلك شيء تماما كما حدث في الجزائر التي لم تنفذ فيها قوانين التعريـب. ولا بد من مواجهة حقيقية لذلك التيار التغريبي تتم على مستوى استراتيجي وسياسي وحضاري ([14]).
2- عوائق نابعة من التبعية السياسية والثقافية:
لقد استطاع الاستعمار بكل ما أوتي من قوى أن يستحوذ على البلدان المغلوبة على أمرها، وأن ينشئ خطابا لغويا استعماريا حول اللغة والثقافة يقدح في ثقافة تلك البلدان ويغض من شأنها الحضاري والتاريخي، زاعما أن اللغات الأوربية هي اللغات الجديرة بحمل العلم والحضارة والثقافة، وأنه لا يمكن تحصيل التقدم والرقي إلا بها، ولا يولج إلى عالم الحداثة والمعاصرة إلا بواسطتها، أما ما عداها فلا يعدو أن يكون لهجات أو لغيَّات أو لغات قديمة لا تقوى على حمل الأفكار الحديثة والمفاهيم العلمية الجديدة، ولم تلبث أهداف الخطاب الاستعماري العنصرية أن تغلغلت في نفوس كثير من أبناء هذه الأمة، فباتوا يستمسكون بها ويدافعون عنها ويتبنونها([15]).
إن هذا الصراع اللغوي هو في حقيقته صراع أمتنا بين البقاء في التبعية الفكرية والحضارية والسياسية من ناحية، والتحرر والإبداع والمشاركة الأصيلة في بناء الحضارة العالمية من ناحية أخرى. وإن وضع آلاف المصطلحات العلمية وتكديسها على رفوف المكتبات لا يعني شيئا، إذا لم تصبح اللغة العربية الفصحى لغة التدريس في جميع مستوياته، ولغة البحث العلمي والتقنيات الحديثة ([16]).
هذا إلى أن الفكر الأصيل لا يخلق في الأمة إلا إذا كانت تعلِّم بلغتها، وتكتب وتؤلف بلغتها أيضا... ([17]).
ولا جدال في أن حياة كل لغة مرتبطة بقدرتها على استيعاب كل ما يطرأ عليها من جديد في الفكر والثقافة والعلوم والتقنية؛ ولكي تواكب اللغة العربية طوفان التقدم الحضاري العالمي، فلابد لها من التنمية اللغوية، التي تثري اللغة بالمفردات والأساليب والمصطلحات العلمية، ويتحقق ذلك بالتعريب اللغوي الذي يمنح العربية فرصة التفاعل في البيئات العلمية فيزيد من ثروتها، وينمي محصولها والتعامل بها، وبذلك ينزاح عنها توهم ضعفها واتهامها بالعجز عن ملاحقة العلوم وما يجد فيها من تطور ([18]).
3- عوائق نابعة من انتشار المدارس والجامعات الأجنبية:
من العوائق التي تحول دون بسط اللغة العربية لنفوذها، وانتشارها داخل بلادنا، انتشار التعليم الأجنبي على نطاق واسع تجلت مظاهره في الآتي ([19]):
1- مشاركة الحكومة في رقعة مدارس اللغات وبسط سلطانها ومد نفوذها وهيمنتها على توجهات أكثر المشاركين في العملية التعليمية، وذلك حين أنشأت ما يسمى بالمدارس التجريبية للغات؛ لتكون دعاية حكومية رسمية لهذه المدارس، وهي جرثومة الاحتلال الفكري، من جهة والسبب المباشر في تحويل العلم إلى سلعة لا يحصل عليها إلا القادرون من جهة أخرى.
2- إنشاء الأقسام الإنجليزية والفرنسية في كليات التجارة والحقوق بغير ما ضرورة داعية أو حاجة ملحة؛ إذ تؤدي هذه الكليات وظيفتها كاملة باللغة العربية منذ عشرات السنين.
3- إنشاء جامعات حكومية إنجليزية وفرنسية وألمانية؛ لاستيعاب المتخرجين في مدارس هذه اللغات الثلاث، ليكون تثبيتا رسميا وإعلانا حكوميا لمدارس هذه اللغات من جهة، ولفكرة التعليم بغير العربية من جهة أخرى.
4- مشاركة الأزهر الشريف – وهو آخر الحصون – في أعمال التعويق وسد منافذ الانطلاق أمام العربية، خلافا لما يرجى عنده، حين جعل التعليم بالإنجليزية في معاهده المحدثة بعد تطويره، غير عابئ بدعوات التعريب وتجاربه الناجحة في سوريا وغيرها. وكذلك حين شارك في سباق مدارس اللغات؛ فأنشأ ما يعرف بالمعاهد الأزهرية النموذجية للغات.
إن كل دولة من الدول الكبرى - صاحبة السطوة والنفوذ- أصبحت تقتحم الدول العربية، بدعوى العولمة، ونقل التقدم العلمي والمعارف الحديثة إليها، كل ذلك لكي تبسط لغتها وثقافتها، فرأينا التعليم باللغات الأجنبية في مصر فيما يشبه " الاستعمار اللغوي". أو هو كذلك؛ فهناك الجامعات: الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والألمانية، والروسية، والبقية تأتي.
بل أصبح خريخ الجامعات الأجنبية في البلاد العربية، وفي القلب منها مصر، محتفى به في المحافل، وله السبق والحظوة في التوظيف. ونحن إذا حللنا هذه الظاهرة، سنجد أنها تؤدي إلى مخاطر اجتماعية ثقافية على رأسها إنكار الأساس الأصيل للمواطنة وتكافؤ الفرص، وهو أن التعليم ينبغي أن يكون للقدرات والمواهب العقلية وليس للمال والطبقة الاجتماعية. كما تؤدي إلى انهيار قيمة الهوية والانتماء والخصوصية ووحدة الشخصية والذاتية القومية، من حيث ما يؤدى إليه هذا النوع من التعليم باللغات الأجنبية من تعدد وتباين وشعور بالدونية لمن يتعلمون بالعربية ([20]).
أما الخريج الآخر، أعني خريج الجامعات المصرية، فقد تراجعت قيمته العلمية، تراجعا يصيبنا جميعا بالخزي، ويجعل هناك مرارة في الحلق، لن يزيلها إلا عودة الأمور إلى نصابها، وبخاصة بعد التغيير الذي حدث، بعد ثورة 25 يناير. التي يجب أن تُرفع في ظلها راية العزة والكرامة للغة العربية، والتعليم بها في كل ربوع مصر، في كل مستويات التعليم.
ثانيا- أسباب استعمال اللغة الأجنبية في التعليم:
هناك دراسات ميدانية سابقة أثبتت النتائج الآتية في هذا الصدد:
الدراسة الأولى حول استخدام اللغة الإنجليزية في التدريس الجامعي ([21]). أظهرت هذه الدراسة أن أهم أسباب استخدام اللغة الإنجليزية في التعليم الجامعي، هي:
1- اللغة الإنجليزية منتشرة في أنحاء العالم (91%).
2- اللغة الإنجليزية لغة العولمة (80%).
3- اللغة الإنجليزية تواكب التقدم والتطور (81%).
4- اللغة الإنجليزية تتوفر فيها المراجع والدراسات الحديثة (80%).
5- المراجع باللغة العربية قديمة لا جديد فيها (78%).
6- اللغة الإنجليزية تسهل على الباحث التواصل مع الآخرين في شؤون التخصص (76%).
7- التعليم باللغة الإنجليزية يظهر أن صاحبه يرغب تقليد الغرب (68%).
8- اختيار المصطلح الأحنبي لعدم معرفة ما يقابله بالعربية (60%).
9- قلة التمكن من العربية يدفع الأستاذ إلى استخدام الاسم الأجنبي (53%).
10- اختيار التعليم باللغة الإنجليزية لأن اللغة العربية أصبحت بالية وقديمة (51%).
11- تُمكن الطالب من التواصل مع الإنترنت (83%).
وأتفق مع الباحث في أن هذه الانطباعات التي تمخض عنها الاستطلاع السابق، يشف عن أسباب ثقافية وحضارية – في الأغلب- وتنطوي على استلاب نفسي نحو ثقافة الآخر (القوي والمتقدم تقنيا) في التعليم باللغة الإنجليزية. فكثير من مستخدمي اللغة الأجنبية في التعليم، لا ينبعث موقفهم هذا من اعتقادهم بعجزهم في اللغة العربية، أو عجز العربية عن الأداء بقدر ما هو إعجاب يصل إلى حد الاستسلام للحضارة الغربية، وتقليد الخصم في كل ما صدر عنه، أو ما يسمى" الإحساس بالدونية وعقدة النقص".
أما الدراسة الثانية، فهي للدكتورة ليلى يوسف حميد ([22])، وانحصرت إجابات أفراد العينة من الأساتذة والطلاب عن أسباب تأخر التعريب في مصر، واستعمال اللغة الأجنبية في التعليم، في الآتي:
الرغبة في تقليد المجتمعات الغربية في كل شيء حتى في اللغة.
التأخر العلمي والحضاري الذي جعلنا نستورد كل شيء.
عدم اهتمام الدولة بتشجيع حركة الترجمة العلمية.
التبعية السياسية التي سمحت بانتشار الاستعمار اللغوي في كل مجالات حياتنا وبخاصة الثقافية منها.
الفكر السائد بين الناس بأن الدراسة باللغات الأجنبية دليل على التقدم.
أن الجهات الرسمية والحكومية لم تول الأمر العناية اللازمة.
الدراسة في الماجستير والدكتوراه في الدول الأجنبية.
صعوبة توحيد الجهود لإنجاز عمل علمي مشترك.
عدم وجود هيئات ومنظمات ذات كفاءة في مجال التعريب.
السياسات التعليمية الفاشلة والمتغيرة التي لا تستقر على حال.
الاستعمار البريطاني لمصر.
شيوع العامية وطغيانها على الفصحى حجبها عن المشاركة والتفاعل.
بسبب مشكلة المصطلح العلمي اللاتيني في كل العلوم.
ضعف مستوى المحاضرين في اللغة العربية بحجة تخصصاتهم العلمية وعدم قدرتهم على التواصل بها في مجال العلم.
الاعتقاد بأن من يتكلم الإنجليزية يعرف أكثر في تخصصه من الذي يتكلم بالعربية.
انتشار مدارس اللغات الأجنبية في مصر.
ونستطيع أن نعلق على هذه النتيجة فنقول: إنه يمكن إرجاع تلك الأسباب إلى أسباب علمية ولغوية، كما ورد في الأسباب: 2-3-7-8-9-11-12-13. وأسباب سياسية، كما في:5- 9- 10-15. وأسباب ثقافية تخص المجتمع، كما في: 1- 4- 6-14.
وكل مجموعة من هذه المجموعات تحتاج إلى علاج مستقل، توضع آلياته وإجرآته، وتشرف الدولة على تنفيذه، وترصد له الدعم المالي المناسب، إذا أردنا التقدم في هذا المجال، والتغلب على هذه المشكلة التي تتفاقم يوما بعد يوم. ولعل مصر بعد ثورة 25 يناير تكون أمضى عزما في إعطاء هذا الملف حقه من الاهتمام.
ثالثا: هل العلوم – فعلا – لا يمكن أن تعلم إلا عن طريق لغتها الأصلية؟
إن نتائج التجارب والدراسات السابقة قد حسمت هذه القضية بل إن الواقع يؤكد أن بعض دول العالم التي تدرس الطب تدرسه بلغتها القومية، كدراسته في ألمانيا وروسيا واليابان والصين وفرنسا، فكل أولئك يدرسونه بلغتهم القومية. وكذلك الطب في سوريا والسودان والجزائر. وكلها تجارب ناجحة.
إن تجربة سوريا في تعليم الطب بالعربية أثبتت قدرة العربية على مسايرة التقدم الحديث في المجال الطبي، وإمكانية ذلك. وكانت مصر رائدة في ذلك، إذ أن تجربة تدريس الطب باللغة العربية في أول مدرسة للطب الحديث التي أسسها محمد على، وبدأ التدريس فيها باللغة العربية عام 1827م.
ومن نتائج الدراسات السابقة، دراسة د. زهير سباعي ([23]) التي كان من نتائجها:
- استطاعة كل من طالب الطب والطبيب قراءة النص الطبي باللغة العربية بسرعة تفوق سرعته في قراءة النص نفسه باللغة الإنجليزية بحوالي (43%)، كما أن قدرته على استيعاب النص باللغة العربية أفضل (15%) من استيعابه للنص باللغة الإنجليزية.
- أما الدراسة الثانية فهي للدكتور سعد الراجحي والدكتور أمير بيومي حول "كفاءة التعليم الهندسي بلغة أجنبية"([24])، واعتمدا على دراسة حالات 1500 طالب بالسنة الإعدادية في الكلية، و1500 شخص أنهوا دراسة الهندسة، ثم (400) من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. وكانت نتائج الدراسة كالآتي:
- الملاحظة الأولى التي سجلتها دراسة حالات طلاب السنة الإعدادية أو طلاب الدراسات العليا الذين يفترض أنهم درسوا مناهجهم باللغة الإنجليزية في الكلية على مدى خمس سنوات؛ أن المستوى العام ضعيف في اللغة الإنجليزية للجميع.
- الملاحظة الثانية: طلاب الدراسات العليا الذين يلتحقون ببعض الجامعات الأمريكية، يشترط عليهم الحصول على مستوى معين من الدرجات في امتحان "التوفل" وقد لاحظ الباحثان أن أغلب المصريين المتقدمين لهذا الامتحان، ومعظمهم من أوائل الخريجين، يضطرون إلى إعادته عدة مرات قبل الحصول على الدرجات المطلوبة. وفي الواقع، فإنهم يحصلون في النهاية على تلك الدرجات من خلال الاعتياد على نوعية الأسئلة، وليس نتيجة لتمكنهم من اللغة الإنجليزية.
- رأى 67% من الطلاب والخريجيين الذين شملتهم الاستبانة أن مستوى أعضاء هيئة التدريس جيد في اللغة الإنجليزية، في حين ذهب الباقون إلى أن مستواهم متوسط أو ضعيف، على الرغم من حصول 57% من أعضاء هيئة التدريس بالعينة على الدكتوراه من دول تتحدث الإنجليزية.
- الملاحظة الثالثة: كانت حول تقدير حاجة الخريجين إلى اللغة الإنجليزية، إذ المفهوم والشائع أن تدريس الهندسة باللغة الإنجليزية هدفه تأهيل الطلاب للقراءة والاطلاع على المراجع الأجنبية بعد التخرج، وكذلك التعامل مع هذه اللغة حسب حاجة العمل. غير أن نتائج الاستبانة قللت كثيرا من أهمية هذا الجانب واعتبرته من قبيل الإسراف في الثمن أو الوهم.. كيف؟
- تبين أن 42% فقط من الخريجين الذين شملتهم الاستبانة قرأوا أقل من ثلاثة كتب منذ تخرجهم، أي خلال سبع سنوات في المتوسط.
- تبين أيضا أن 32% من الخريجين الذين شملتهم الاستبانة احتاجوا إلى التعامل أحيانا في عملهم مع بعض الأجانب في مصر.
- تبين كذلك أن 19% فقط من هؤلاء الخريجين سافروا إلى الخارج لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وهي المدد التي تستلزم إجادة سابقة للغة.
الملاحظة الرابعة والأخيرة:
- دلت نتائج الاستبانة فيما يشبه الإجماع على أن أنشطة التعليم المختلفة باستثناء الامتحانات – لا تتم عمليا باللغة الإنجليزية، كما هو مفترض من الناحية الرسمية، صحيح أن الكتي والمذكرات مدونة باللغة الإنجليزية إلا أن الشرح في كل ساعات التدريس (3750) ساعة من المحاضرات والتمارين، يتم في مرحلة الكالوريوس باللغة العربية، في حين تنطق المصطلحات فقط باللغة الإنجليزية.
في الوقت ذاته رأى 53% من أعضاء هيئة التدريس الذين شملتهم الاستبانة أن الطلاب لا يستوعبون معاني المصطلحات، بل يحفظونها دون فهم. وقرر 25% من أعضاء هيئة التدريس في العينة السماح للطلاب باستخدام خليط من اللغة العربية واللغة الإنجليزية لإجابة عن أسئلة الامتحانات، حتى لا تقف اللغة حائلا أمام معرفة مستواهم الحقيقي في موضوع الامتحان.
وفي النهاية خلص الباحثان إلى أن كفاءة مسنوى الطلاب في الهندسة ذاتها يرجع إلى أن الإنجليزية لا تستخدم بالفعل في التدريس، وأن اهتمامهم بموضوع لغة التعليم مرده القلق، والوقت والجهد والمال الضائع في الدروس الخصوصية التي يعتبر استخدام الإنجليزية رسميا أحد أسباها البارزة.
إن الأمم التي أشرنا إليها آنفا لم تستغن عن لغتها القومية، وبرعت في ميدان العلوم الحديثة. فهذه الولايات المتحدة الأمريكية نراها عندما أطلقت روسيا أول صاروخ فضائي عام 1957، لم تحول التعليم فيها باللغة الروسية، وإنما شعرت بأهمية إعادة النظر في نظريات تعليم اللغات الأجنبية، لكيلا تجد نفسها معزولة عن التقدم العلمي الذي يجري في الدول الأخرى.
والذي ينبغي ألا ننكره أن إصرارنا على التعليم بالأجنبية هو في المقابل اعتراف منا بعجز العربية عن مسايرة المعارف والعلوم الحديثة. وهذا غير صحيح. كما أثبتت الدراسات ([25]).
فلغة المرء أيسر وسيلة لنقل المعرفة إليه، ومن ثم الجهد الذي يبذله لاستيعاب المعارف بغير لغته يحتاج إلى أضعاف الوقت الذي يبذله لكي يتحقق له ذلك الاستيعاب بلغته الأصلية. الأمر الذي يعني أن كل تعليم باللغة الأجنبية، يضيف معارف أقل ويحقق تشوها ثقافيا أكبر. وغني عن القول أن تعلم اللغة الأجنبية شيء، وأن التعليم باللغة الأجنبية شيء آخر، فالأولى إضافة بامتياز، والثانية خسران بامتياز.
إن استمرار التدريس باللغة الأجنبية في الجامعات المصرية، كما يذكر أحد الباحثين([26]) يعوق قدرتنا على الانطلاق والتقدم، لأنه يحد من قدرة الباحثين على الاستيعاب، ومن ثم قدرتهم على الابتكار والإبداع. وما أصحاب اللغة العبرية من ببعيد، فقد أحيت إسرائيل اللغة العبرية التي كانت ميتة، وأصبحت تستمتع بالدراسة والبحث بلغتها([27]).
رابعًا: أهمية التعليم باللغة العربية في نهضة الأمة ([28]):
تجمع البحوث التربوية الحديثة على أن الإنسان يستوعب بلغته الأم (القومية) أضعاف أضعاف ما يستوعبه باللغة الأجنبية، مهما كانت درجة إتقانه لهذه اللغة. وقد دلت البحوث قديما وحديثا، أنه لا توجد لغة عاجزة عن استيعاب المعرفة الإنسانية، ولكن العجز يكمن في أهلها، وفي تخلفهم الحضاري والفكري. وقد اجتازت العربية هذه التجربة في تاؤيخها القديم، ومنذ نزول القرآن الكريم وحيا إلهيا على الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. وازدهرت حضارة عربية إسلامية من الصين شرقا إلى الأندلس وأطراف أوربا غربا. وكانت العربية لغة هذه الحضارة، ولغة العلم الأولى لعدة قرون([29]).
ويكاد يكون من المسلمات أيضا، عند أهل العلم والدراية، أن الذي يعبر بلسان قوم يفكر بعقلهم، ويتم درس بثقافتهم، وتصاغ شخصيته وفق معاييرهم، هذا عدا عن القطيعة مع نسقه المعرفي، ومخزونه التراثي وقيمه ومعاييره الضابطة لمسالكه، ومرجعيته، وارتكازه الحضاري، فعجمة اللسان تؤدي إلى عجمة العقل والقلب وغربة النفس.
ولقد نبه علماء السلف منذ وقت مبكر على أثر اللغة ودورها في التفكير وصياغة الشخصية. حيث يقول ابن تيمية رحمه الله: "إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، تأثيرا قويا بينا "مؤكدا أن " العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، وفهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
ويقول ابن حزم في كتابه الإحكام: “اللغة يسقط أكثرها بسقوط همة أهلها".
إن اللغة بما تبني في العقل والخيال والشعور والأثر، وبما تحققه من ارتباط بين الأصوات والمعاني، من حس وفهم مشترك، تقيم القاعدة المشتركة، وتوسع دائرة التفاهم، وتوحد المسارات الكبرى لحركة الأمة وتفاهم الأفراد وتواصلهم. فاللغة نافذة الشخصية، ومرآة العقل: "تكلم حتى أراك"، أو هي الشخصية بكل مواصفاتها.
إن عدم إدراك أهمية اللغة ودورها في بناء الأمم، وصياغة شخصيتها، وتشكيل ثقافتها، هو من الطوام الكبرى والمؤامرات الخطيرة، سواء حصل على يد الجهلـة من أبنائها، أو المكر الخبيث من أعدائها، مهما اجتهدوا في وضع المسوغات والفلسفات في محاولاتهم لإقصاء اللغة واستبدالها.
وكأن الأمة تريد أن تلقي بعجزها وتخاذله وتخلفها واستعمارها الثقافي على اللغة، دون أن تدري أن الإنسان وتخاذله وعجزه هو المشكلة، وليست اللغة وإمكاناتها وقابليتها.
ونحن عندما نتكلم عن أهمية اللغة العربية في حدة الأمة، ودورها في التشكيل الثقافي وبناء النسيج الاجتماعي، وأن الإنسان هو اللغة، لا نعني الحط من قيمة اللغات الأخرى، ولا من أهميتها وضرورة تعلمها، " ولكن هناك فرق بين تعلم اللغات الأجنبية والتعليم باللغات الأجنبية، فالأول ندفع فيه بقوة ونحبذه، والثاني نرفضه ولا نقبله.
إن اختيار العربية من بين سائر لغات العالم لتكون لغة التنزيل للرسالة العالمية الخاتمة الخالدة، ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [الأنعام:124]، يعني أن العربية قادرة على أن تستوعب حركة العالم، بكل تطوراته ومتغيرات واختلافاته، وتمتلك المرونة والقدرة للتعبير عنها، والتفكير فيها، وتوليد الأحكام والمصطلحات المحركة لها ابتداء والمستوعبة لحركتها انتهاء.
إن اللغة هي المقوم الأهم لتشكيل الأمم وبناء ثقافتها. وأن محاولات الفصل بين التفكير والتعبير نوع من خداع النفس، وأن التعبير بلسان قوم تفكير بعقولهم – كما سبق- وأن الإحاطة بثقافة أمة وفهمها لا يتحقق إلا مت خلال لسانها، مهما كانت الترجمات دقيقة، وأن العلاقة بين الأمم ولغاتها علاقة تبادلية، صعودا وهبوطا؛ فالمعاصرة الحضارية والتواصل الثقافي، يقتضيان المشاركة الفعالة والحضور الجاد بين الأمم، ولا يتم ذلك إلا بتطوير اللغة العربية.
خامسًا: مخاطر التعليم باللغات الأجنبية:
إن إتقان لغة أجنبية يمكن صاحبه من أن يطلع على ما عند الآخرين، وبخاصة اللغات ذائعة الانتشار، فنحن لا نعترض على ذلك، فهذا – كما أشرنا – مطلوب بامتياز. أما الذي نعترض عليه، فهو التعليم باللغات الأجنبية؛ بمعنى أن يتلقى المتعلم تعليمه في كل العلوم بلغة أجنبية غير لغته القومي.
وقد رصدت بعض الدراسات السابقة ([30]) عددا من هذه المخاطر، وحذرت من التعليم بلغة أجنبية. ومن هذه المخاطر:
1- اضطراب الهوية الثقافية:
فاللغة هي التي تعطي المجتمع اسمه، وللوطن عنوانه، ولا غرو في ذلك، فاللغة وطريقة التعبير عن الأفكار والمشاعر والوجدان هي التي تجمع بين أفراد الوطن الواحد. ولكل مجتمع ثقافته، وهي مجمل أساليب السلوك والحياة فيه ([31]).
والثقافة كما يقول الأستاذ محمود شاكر – رحمه الله: لفظ جامع يقصد به الدلالة على شيئين أحدهما مبني على الآخر، أي هما طوران متكاملان:
الطور الأول: أصول ثابتة مكتسبة تنغرس في نفس الإنسان منذ مولده ونشأته الأولى حتى يشارف حد الإدراك البيِّن... وهذه الأصول ضرورة لازمة لكل حي ناشئ في مجتمع ما، لكي تكون له "لغة" يُبِين بها عن نفسه، و "معرفة" تتيح له قسطا من التفكير يعينه على معاشرة من نشأ بينهم من أهله وعشيرته.
الطور الثاني: فروع منبعثة عن هذه الأصول المكتسبة بالنشأة، وهي تنبثق حين يخرج الناشئ من إسار التسخير إلى طلاقة التفكير، والتعبير عن الرأي الذي هو نتاج مزاولة العقل لعمله، فعندئذ، تتكون النواة الجديدة لما يمكن أن يسمى " ثقافة". وبيَّن أن سبيله إلى تحقيق ذلك هو " اللغة " و "المعارف"([32]).
وثقافة كل أمة وكل "لغة" هي حصيلة أبنائها المثقفين بقدر مشترك من أصول وفروع، كلها مغموس في " الدين " المتلقى عند النشأة... فثقافة كل أمة مرآة جامعة في حيزها المحدود لكل ما تشتت من ثقافة كل فرد من أبنائها على اختلاف مشاربهـم. وجوهر هذه المرآة هو " اللغة"، و"اللغة" و"الدين" متداخلان تداخلا غير قابل للفص البتة. فاللغة وعاء الثقافة ([33]).
فالتعليم باللغات الأجنبية سوف ينشئ أجيالا تتهتك علائقها التي تربطها بثقافتها العربية والإسلامية، اجتماعيا وثقافيا ولغويا ([34]). ولأن العلاقة وثيقة بين اللغة والهوية الثقافية للمجتمع، فإن القوى الاستعمارية كانت تعمد دائما إلى إضعاف اللغة القومية في البلاد التي تحتلها، إدراكا منها أنها إذا نجحت في هذا الهدف، فإن المجتمع يتعرض لحالة من الذوبان، وتتميع هويته وتضعف فيه روح الكفاح، مما يجعله لقمة سائغة للمستعمر ([35]). وفي ذلك يقول العقاد: "لقد تعرضت – اللغة العربية – وحدها من بين لغات اللعالم لكل ما ينصب عليها من معاول الهدم ويحيط بها من دسائس الراصدين لها؛ لأنها قوام فكرة وثقافة وعلاقة تاريخية".
2- سوء التوافق والاغتراب والعزلة:
فالنظم التعليمية التي تقدم تعليمها بلغة أجنبية لا تقدم هذا التعليم لكل أبناء المجتمع، بل إنه سيكون تعليما فئويا خاصا بمن يقدر على دفع تكاليف هذا التعليم الباهظة. ويبقى بقية المتعلمين الذين يحصلون على التعليم باللغة القومية وهم أبناء سواد الشعب من الفقراء، وكأننا أمام شعبين أو ثقافتين. وأن أبناء الصفوة الذين تعلموا باللغة الأجنبية قد يشعرون بعدم الاندماج أو بالانفصال عن أبناء مجتمعهم وعن أحلامهم، وهو ما يعكس سوء توافقهم مع مجتمعهم وعزلتهم عن الثقافة السائدة في المجتمع. والأشخاص الذين يحيون حياة عزلة واغتراب لا يرون قيمة كبيرة لكثير من الأهداف والمفاهيم التي يثمنها المجتمع ويضطلع بها ([36]).
3- ضعف الفهم والتحصيل والإبداع:
فالفرد يفهم ويبدع بلغته القومية أكثر مما يفهم باللغة الأجنبية. ويؤكد ذلك الدراسات التي تمت حول استيعاب طلبة الجامعة في المواد التي تدرس باللغة الأجنبية؛ إذ أثبتت هذه الدراسات انخفاض مستوى تحصيل الطلاب في المرحلة الجامعية في الكليات التي تقدم علومها بلغات أجنبية قياسا إلى تحصيلهم في المرحلة قبل الجامعية[37].
أما الإبداع، فلا يكون إلا من خلال اللغة الأولى القومية. فاللغة الأصلية هي التي تسعف الفرد في إبداعاته؛ لأنها صاغت وجدانه ومشاعره ومفاهيمه.
4- تجارب الأمم الأخرى:
ونظرة إلى الأمم الأخرى في هذا الميدان نلاحظ مثلا أن فرنسا أصدرت قانونا لحماية اللغة حمل اسم "قانون لزوم الفرنسية" نص على منع أي مواطن من استخدام ألفاظ أو عبارات أجنبية، مادامت هناك ألفاظ أو عبارات مماثلة تؤدي ذات المعنى في الفرنسية. والمجالات التي سرى عليه الحظر هي: كافة الوثائق والمستندات والإعلانات المسموعة أو المرئية المعروضة على الجمهور، وكافة مكاتبات الشركات العاملة على الأرض الفرنسية، حتى وإن كانت أجنبية. كذلك شمل قانون لزوم الفرنسية كل المحلات التجارية والأفلام الدعائية التي تبث عبر الإذاعة والتلفزيون. وأكثر من ذلك، فإن القانون اشترط على الجهات المحلية والحكومية ألا تمول سوى تلك المؤتمرات والابحاث التي قدمها أجانب بلغاتهم الأصلية ما لم تكن مصحوبة بملخص مكتوب باللغة الفرنسية، وكل من يخالف نصوص هذا القانون يعاقب بغرامة تعادل مبلغا يتراوح بين 100 و300 دولار.
بل إن فرنسا تمنع التلميذ الفرنسي منة ان يتعلم لغة اجنبية في المرحلة الابتدائية حفاظا على شخصية الوطنية في هذه السن الباكرة.
إنهم يعملون على نقاء لسان الطفل الفرنسي، ويعتبرون ذلك النقاء إحدى ركائز الشخصية الوطنية التي تتشكل لدى الأجيال الجديدة في بداية سلم التعليم، ويخشون على لسان الطفل ووجدانه من لغة أخرى مثل العربية التي هي أضعف بامتياز.
وهذا لابد أن يذكرنا بالمفارقة العجيبة التي تحدث في عالمنا العربي، حيث تلوى ألسنة الصغار وهم في مرحلة الحضانة فصاعدا، بالرطانة الإنجليزية والفرنسية، مما يؤثر قطعا على وجدان هؤلاء الصغار وشخصيتهم الوطنية.
وهذا الزعيم الفيتنامي (هوتشي منه) يوجه قومه إلى تأكيد هوية بلاده (أطلق عليها وصف الفتنمة)، يقول لهم: حافظوا على صفاء اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء عيونكم، تجنبوا بعناد أن تستعملوا كلمة أجنبية حين يصبح بإمكانكم أن تستعملوا المفردات الفيتنامية.
وهذا زعيم تانزانيا (يوليوس نيريري) يتصدى بقوة بعد الاستقلال للدفاع عن السواحلية، اللغة الوطنية لبلاده، حتى أصبحت جامعة دار السلام تدرس سائر المواد بما فيها الطب والهندسة باللغة السواحلية. قل مثل ذلك في العديد من الدول الآسيوية التي اعتبرت اللغة إحدى رايات كبريائها الوطنية، فحرصت على أن تظل مرفوعة الرأس دائما، واعتبرت تنكيس تلك الراية من آيات الهزيمة والانكسار ([38]).
ويبقى كما يقول د سيف عبد الفتاح ([39])، إن أحد المؤشرات المهمة على تحضُّر شعب من الشعوب هو علاقته بلغته: كيف ينظر إليها؟ وكيف يتعامل معها؟ ثم كم هي قدرات لغته في التعامل مع نمط الحياة السائدة؟
واللغة العربية من هذه الزاوية في مأزق؛ فهي تعيش في ظل حضارة ليست من صنع أبنائها، حضارة شكلت أنفسها نظاما فكريا، وتصورات عقائدية عن الكون مخالفا في كثير من نواحيه للنظام الفكري الذي عاشت في ظله اللغة العربية، كما أن هذه الحضارة ابتدعت علوما ومناهج للبحث العلمي لم تألفها الحضارة العربية من قبل، وأنجزت منتجات، زصاحب هذه المنتجات عادات وتقاليد خاصة، كل هذا كان غريبا عن العرب وكان مأزقا تواجهه اللغة العربية كل يوم.
في ظل هذا الإحساس القوي بالتفوق تجاه الغير، عامل القدماء لغتهم، ونظروا إليها على أنها أفضل اللغات جميعا، وأقدرها على التعبير عن العواطف الإنسانية ومقتضيات الحياة اليومية، تجد ذلك مبثوثا في كتابات الجاحظ، وغيره ممن كتبوا عن إعجاز القرآن الكريم ولغته.
ثم تغيَّب الدور الحضاري الفعال للعرب لأسباب كثيرة ومعروفة، وبدأ اهتمامهم بلغتهم يقل تبعا لذلك، توقف العرب عن الاهتمام بلغتهم تزامن مع الانهيار العام لكل مظاهر الحضارة التي شادوها عبر مئات السنين.
ولعل أهم هذه التناقضات أن العرب فشلوا حتى الآن أن يكونوا عنصرا فعالا ومؤثرا في الحضارة، على حين نجح غيرهم. هناك إحساس عام غير معلن أننا لن نكون مثلهم، وأن قدرنا هو أن نأخذ منهم دائما، ليست هناك بادرة طموح في تجاوز الوضع القائم، وإلى المشاركة الفعَّلة في العصر، وربما كان أهم انعكاس لهذا الإحساس العام هو في تعاملنا الرديء مع اللغة العربية. لقد آن الأوان وفي هذه الظروف التي تمر بها بلادنا أن يكون الدور الأكثر أهمية هو وجوب البحث في كيف يمكن لكل عربي أن يكون فاهما للغته متقنا لها معتزا بها فخورا بانتسابه إليها؛ فتكون مناط عزته وهويته وروح الوعي والمقاومة عنده.
- أن تتخذ الدولة قرارا سياديا بوجوب جعل اللغة العربية لغة البحث العلمي والتدريس في جميع مراحله.
- أن تفرض الجامعات في جميع الكليات مستوى معينا في اللغة العربية يعتبر متطلبا أساسيا لتتخرُّج الطالب الجامعي في مجال تخصصه.
- إنشاء مراكز علمية متخصصة في جميع حقول المعرفة من أجل جمع الأعمال العلمية في أهم اللغات الحية وفهرستها لمساعدة الباحثين وأساتذة الجامعات في بحوثهم وإعداد محاضراتهم.
- إنشاء مركز رئيسي للتعريب والترجمة والنشر.
- وضع خطة شاملة للتأليف باللغة العربية في المجالات العلمية، يتحدد فيها الموضوعات ومستوى التأليف فيها عن طريق الالتجاء إلى متخصصين عرب لأداء هذه الرسالة.
- وضع خطة شاملة للتعريب لبعض أمهات الكتب في كل مجال علمي، وبخاصة الكتب الدراسية.
- تنسيق الجهود في تعريب المصطلح العلمي في الوطن العربي عن طريق المجامع اللغوية.
- تدريب مدرسي اللغة العربية بوساطة مناهج متطورة مقابل مضاعفة مرتباتهم.
- العودة إلى تحفيظ ثلاثة أجزاء من القرآن على الأقل على كل الطلبة في المرحلة الابتدائية خاصة.
10- العناية بالتأليف ثنائي اللغة كمرحلة انتقالية.
11- تجريم أو تحريم أي إعلان في الصحف المحلية بحروف معربة" تيك أواي، دريم لاند... إلخ".
12- الإلزام بترجمة أي إعلان باللغة الأجنبية إلى العربية.
13- النظر في ربط الترقي في الجامعة من درجة إلى الدرجة الأعلى بإعطاء محاضرة بالعربية، وتقديم بحث بالعربية، وامتحان في اللغة العربية.
14- توفير المصادر المالية والميزانيات والمساهمات الخاصة بتنفيذ هذه الخطط في شكل برامج تنفيذية واقعية ودقيقة.
وبعد، فإن استمرار الحديث في هذا الموضوع، وعقد الندوات والمؤتمرات، سيظل مطلبا رئيسا، حتى نتغلب على الرواسب النفسية المتمثلة في العقدة أمام تفوق الأجنبي، وحتى يتسنى لنا إعادة اللغة العربية إلى مكانها اللائق بها، ولن يتأتى ذلك إلا بسواعد أبنائها، وإثبات جدارتهم وتفوقهم في كل الميادين، ليس هذا فحسب؛ ولكن بشرط أن تكون اللغة العربية هي وسيلة التعبير، ونقل الفكر والعلم، وليس غيرها، عند العرب والمسلمين. والله من وراء القصد.
([1]) د. عبد الرحمن بو درع وآخران. اللغة وبناء الذات. كتاب الأمة،العدد101 ،جمادى الأولى 1425هـ،السنة الرابعة والعشرون. ص9.
([2]) د. فتحي محمد جمعة. "لغة بلا أمة" جريدة الأهرام المصرية. العدد 124 السنة41302، الأربعاء5 يناير سنة 2000/28رمضان 1420هـ.
([3]) أ. فهمي هويدي. "قرن تغريب الأمة" جريدة الأهرام المصرية. العدد 123 السنة41301،الثلاثاء 4يناير2000/27رمضان 1420هـ.
([4]) اللغة وبناء الذات. مرجع سابق. ص19.
([5]) تعريب الطب. ص 58.
([6]) د. عبد الكريم خليفة. اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث. ص110.
([7]) تعريب الطب. ص58.
([8]) د. عبد الكريم خليفة. اللغة العربية والتعريب. ص177.
([9]) تعريب الطب. ص 58.
([10]) د. عبد الكريم خليفة. اللغة العربية والتعريب. ص177.
([11]) تعريب الطب. ص59.
([12]) السابق.
([13]) اللغة وبناء الذات. مرجع سابق. ص
([14]) فهمي هويدي. "انكسار أمة لا أزمة لغة" الأهرام المصرية. 1991.
([15]) كتاب الأمة. مرجع سابق. ص63.
([16]) د. عبد الكريم خليفة. اللغة العربية والتعريب. ص270.
([17]) السابق. ص171.
([18]) د. كمال بشر. التعريب بين التفكير والتعبير. ص184.
([19]) د. فتحي محمد جمعة. اللغة الرسمية واللغة الأولى. ص 223.
([20]) د. محمود كامل الناقة. "اللغة والهوية شذرات ودلالات ". ص 364.
([21]) د. عيسى برهومة. التعليم بالأجنبية صورة من غربتنا الحضارية. مؤتمر التعليم باللغات الأجنبية المنعقد بدار العلوم. ص206.
([22]) تعريب علوم العصر :ضروراته ومعوقاته دراسة ميدانية. ص 227.
([23]) نسخة مصورة من البحث دون بيانات.
([24]) نسخة مصورة من البحث دون بيانات.
([25]) إبراهيم الدبيان. الصراع اللغوي. ص 23.
([26]) أد. محمود عز الدين. طب القاهرة.
([27]) "إنهم يشوهون وعي أمتنا ". الأستاذ فهمي هويدي
([28]) انظر: ملحق رقم (1).
([29]) د. عبد الكريم خليفة. اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث. ص 117.
([30]) د. علاء كفافي. الآثار النفسية للتعليم باللغة الأجنبية. ص 136.
([31]) السابق ص 136-137.
([32]) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. ص 103-104.
([33]) السابق.
([34]) السابق.
([35]) د. علاء كفافي. الآثار النفسية للتعليم باللغة الأجنبية. ص 137.
([36]) السابق. ص138.
([37]) السابق.
([38]) الأستاذ فهمي هويدي. انكسار أمة لا أزمة لغة. الأهرام 3 أغسطس 1999.
([39]) "اللغة والهوية والسياسة". بحث منشور ضمن اللغة والهوية وحوار الحضارات. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 2006. ص 66-67.
([40]) هذه التوصيات جمعتها ممن كتبوا في هذا المجال وأضفت إليها ما وجدته ضروريا
.